|
التكوينات السياسية والتحول الديمقراطي في اليمن
السبت, 29-مارس-2008
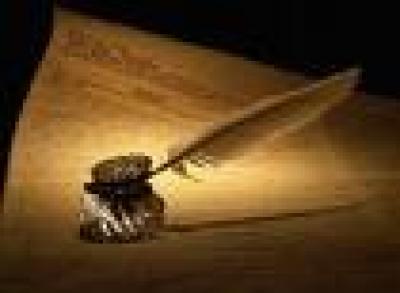 محمد العزي الحميري وطارق عبدالله ثابت - تعد التجربة اليمنية في مجال الديمقراطية والتعددية السياسية, واحدة من أكثر التجارب العربية تميزا, وتستند في ذلك إلي التمازج الواضح الذي شهدته هذه التجربة بين العملية الديمقراطية بمختلف جوانبها من جانب, وبين التركيبة الاجتماعية للمجتمع اليمني من جانب آخر, التي فرضت نفسها علي طبيعة التحول الديمقراطي, الذي تعيشه اليمن, مما أكسب هذه التجربة طابعا خاصا مستمدا من التراث الثقافي والحضاري للشعب اليمني.
وهو ما سنحاول إبرازه من خلال هذه الدراسة وذلك بتقسيمها إلي محورين أساسيين: الأول: يتعلق بواقع الخارطة السياسية و الحزبية اليمنية. والثاني: فيتناول القبيلة ودورها في الحياة السياسية اليمنية.
أولا: واقع الخارطة السياسية والحزبية قبل قيام الوحدة:
ارتبط بروز وتطور الظاهرة الحزبية في اليمن, ببدء ظهور الحركة الوطنية المعارضة لنظامي الحكم القائمين في كلا الشطرين قبل الوحدة- تبعا لخصوصية التغيرات الحاصلة في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية, ومن ثم السياسية في كل شطر منهما- فمنذ النصف الثاني من عقد الثلاثينيات علي أقل تقدير- برزت العديد من الجمعيات و التنظيمات الفكرية والسياسية شبه المنظمة, الشطر الشمالي من اليمن( كهيئة النضال 1935 والجمعية الأدبية لمحبي الأدب 1936, وجمعية الإصلاح 1944) وقد اتفقت في طروحاتها علي ضرورة إجراء إصلاح للنظام السياسي وتعديله- في إطار حركة النقد السياسي والفكري القائمة- بما يتناسب مع ما يحيط به من تطورات داخلية وخارجية, ثم تطورت فيما بعد بسبب ازدياد حالات القمع والاضطهاد والتصفية الجسدية لعناصرها في ظل الحكم الإمامي- تحت شتي المبررات- إلي حركة رفض عنيفة للنظام, اتخذت طابع العمل السياسي السري المنظم ونشطت في أوساط المدنيين والعسكريين علي السواء, وقد مثل البعض منها امتدادا, للتيار القومي النشط في الشطر الجنوبي من اليمن, فبرز منها' حزب البعث الاشتراكي 1958 وحركة القوميين العرب 1959 وحركة الضباط الأحرار1961', وفي المقابل فقد شهدت الساحة السياسية في الشطر الجنوبي من اليمن عموما وعدن علي وجه الخصوص انفتاحا علنيا نسبيا, كان له عظيم الأثر في تطور الحركة الوطنية في عموم البلاد, وبرز منها أحزاب وحركات سياسية كـ'الجمعية الإسلامية' (تيار إسلامي) والجمعية العدنية (تيار وطني) 1949, وحركة القوميين العرب عام 1955 وحزب البعث الاشتراكي عام1956, والحركة الناصرية (تيار قومي), والاتحاد الشعبي الديمقراطي1961' (تيار يساري)(1).
وبمجيء عقد الستينيات وما تلاه دخلت الحركة الوطنية منعطفا جديدا في العمل السياسي والحزبي, ساهمت في ظهوره مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية بدرجات متفاوتة عبر عنه ببروز ظاهرة الكتل الحزبية علي مستوي السلطة والمعارضة في كلا الشطرين, من جراء اتفاق نظامي الحكم بعد الثورة علي وحدة ومركزية السلطة, ونفي التعددية الحزبية, مع المطالبة بالديمقراطية كأساس لإنجاز عملية التوحد الوطني(2). واتخذت لها أشكالا ومسميات مختلفة, لعل أبرزها ما يأتي:
(أ) التنظيمات السياسية الرسمية:
1- الشطر الشمالي: برزت صيغة المؤتمر الشعبي برئاسة المشير عبد الله السلال رئيس الجمهورية عام 1964 وهو عبارة عن تنظيم سياسي بديل للأحزاب السياسية القائمة بكل اتجاهاتها, تغيرت إلي صيغة الاتحاد اليمني في عهد الرئيس عبد الرحمن الأرياني عام 1973, وأخيرا استقرت تحت صيغة المؤتمر الشعبي العام في عام1982(3). واتسمت هذه المرحلة بحالة من الهدوء والاستقرار النسبي, التي انعكست في بعض مظاهرها بتبني السلطة للصيغة الليبرالية غير المعلنة في التعامل مع باقي الأحزاب والقوي السياسية وإجراء انتخابات المجالس البلدية عام 1979 والنيابية 'مجلس الشوري' عام 1988, وإنشاء العديد من المنظمات النقابية والعمالية والمهنية والجمعيات التعاونية(4).
2- الشطر الجنوبي: برزت صيغة الحزب الاشتراكي اليمني عام 1978, باعتباره الصيغة النهائية لحالات الاندماج التنظيمي الحاصل بين فصائل الحركة الوطنية, ابتداء بحركة القوميين العرب مع بعض القوي السياسية عام 1963(5). ومرورا بظهور صيغة منظمة التحرير المكونة من' حزب الشعب الاشتراكي ورابطة أبناء الجنوب اليمني وهيئة تحرير الجنوب اليمني المحتل في عام 1964 وانتهاء ببروز صيغة جبهة تحرير جنوب اليمن المحتل من جراء اندماج الجبهة القومية ومنظمة التحرير عام 1966' وفي30 نوفمبر1967 حصل الشطر الجنوبي من اليمن علي استقلاله من الاحتلال البريطاني, واحتل الطابع الإيدولوجي مكانا بارزا علي الصعيد الداخلي لحكومة الاستقلال تجسد بالصراع بين قوي اليمين واليسار حول تحديد هوية النظام الجديد, انتهي بتغلب الجناح اليساري في الجبهة القومية بعد حركة22 يونيو1969(6). وبرزت أهم مظاهر هذه المرحلة في وضع برنامج شامل للإصلاحات السياسية والاقتصادية المزمع تحقيقها قطفت أولي ثمارها من خلال توسيع الممارسة الديمقراطية والحزبية داخل الحزب الاشتراكي(7).
(ب) التنظيمات السياسية غير الرسمية:
1- برزت في الشطر الشمالي في صورة أحزاب معارضة تعمل في الداخل, تراوحت بين ثلاثة تيارات رئيسية: الأول تيار قومي مثله كل من حزب البعث العربي الاشتراكي بجناحيه العراقي والسوري والحركة الناصرية, والثاني تيار يساري, مثله حزب الوحدة الشعبية والذي ضم في عضويته عدة فصائل وأحزاب سياسية, والثالث: تيار إسلامي, مثله جماعة الإخوان المسلمين.
2- أما أحزاب المعارضة في الشطر الجنوبي, فقد شكلت جبهة واحدة' التجمع القومي لجنوب اليمن' والذي ضم في عضويته القوي والتنظيمات المعارضة في الخارج, واتخذ من القاهرة مقرا له(8).
(ج) واقع الخريطة السياسية بعد الوحدة:
جاء الإعلان عن إعادة توحيد شطري اليمن في22 مايو1990, متلازما مع إعلان شريكي المنجز الوحدوي تبني النهج الديمقراطي والتعددية الحزبية كخيار رئيسي للتداول السلمي علي السلطة, وهو ما مثل تتويجا نهائيا لمجمل التحولات والخطوات الإصلاحية السابقة.
ومن هنا فقد شهدت الساحة السياسية اليمنية ميلاد العديد من الأحزاب والتنظيمات السياسية, التي أعلنت عن نفسها كأحزاب مستقلة, مستندة في شرعيتها إلي دستور دولة الوحدة, إما علي أساس أنها أحزاب قائمة تمارس العمل السياسي بصورة علنية كـ' المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني' أو أنها امتداد للأحزاب والتنظيمات المعارضة التي أنشئت قبل الوحدة بصورة غير دستورية والتي يأتي في مقدمتها الأحزاب المنظوية تحت راية التيارات القومية واليسارية والإسلامية- كما أسلفنا سابقا- أو أنها تشكلت في ظل الوحدة ودستورها(9). وساهم حزبا السلطة في ظهورها, كجزء من مخرجات اللعبة السياسية الدائرة في ظل ما اتفق علي تسميتها من قبل البعض بـ"سياسة تفريخ الأحزاب"(10).
إلا أنه بعد إعادة بلورتها طبقا لمدي حضورها وفعاليتها في الساحة السياسية سواء علي مستوي السلطة أو خارجها حتي عام 2003, برزت أربعة تيارات رئيسة، كما يأتي(11):
1- التيار الوطني مثله حزب المؤتمر الشعبي العام ومجموعة أخري من الأحزاب السياسية التي ظهرت في مطلع التسعينيات مثل التنظيم السبتمبري الديمقراطي, حزب القوي الوحدودية اليمنية, الجبهة الوطنية الديموقراطية, حزب التجمع الوحدوي اليمني. وقد برز المؤتمر الشعبي كحزب بعد فقدانه لطابعه الجبهوي الموحد, من جراء خروج الأحزاب, التي كانت منضوية تحت رايته إلي العلن, وسعيها المتكرر نحو إعادة بناء هيكلها التنظيمي والفكري, بما يتواءم مع التغيرات المحيطة.
2- التيار اليساري مثله الحزب الاشتراكي اليمني ومجموعة أخري برزت في ظل الوحدة مثل' الحزب الثوري اليمني, تنظيم الطلائع اليمني, جبهة التحرير, حزب رابطة أبناء اليمن, الجبهة الشعبية للإنقاذ, منظمة فتيان اليمن, حزب جبهة التحرير, جبهة التصحيح الثوري..'.
3- التيار الإسلامي أعلن عن نفسه عام1990, ومثله ما يربو علي خمسة عشر حزبا وتنظيما سياسيا, لكن معظمها قد انسحبت من الساحة أو ظل حضورها محدودا وموسميا, باستثناء التجمع اليمني للإصلاح, وهو عبارة عن' تجمع يضم ثلاث قوي سياسية متحالفة, هي الجناح القبلي الذي يشكل الهيئة العليا السياسية للتجمع, وتيار الإخوان المسلمين الذي يشكل الجناح التنظيمي والفكري, وشريحة التجار وأصحاب رؤوس الأموال. إضافة إلي مجموعة أخري مثل' حزب الحق الذي أعلن حل نفسه مؤخرا', حزب العمل الإسلامي واتحاد القوي الشعبية و اتحاد القوي الإسلامية الثورية وحزب النهضة الإسلامي(12).
4- التيار القومي مثلته مجموعة من الأحزاب والتنظيمات السياسية والتي يأتي في مقدمتها التنظيمات البعثية بجناحيها العراقي والسوري والتنظيمات الناصرية(13). التي يربو عددها عن الـ13 حزبا, اكبرها التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري, بالإضافة إلي مجموعة أخري مثل' التنظيم الشعبي التقدمي العربي, الحزب القومي الاجتماعي, حزب الوحدة القومي العربي...'.
(د) الأحزاب السياسية وواقع المشاركة السياسية في الانتخابات:
سوف يجري التركيز هنا علي بعض المؤشرات ودلالاتها المأخوذة من تجربتي الانتخابات النيابية والمحلية, نظرا لما مثلته من عامل حاسم في مدي جدية وفعالية التنظيمات والأحزاب العاملة في الساحة, سواء من حيث المشاركة في معظم مراحل العملية الانتخابية من 'إعداد, وإشراف, وتقديم برامج انتخابية, ومرشحين' أو من خلال ما حصلت عليه من مقاعد تحت قبة البرلمان والمجالس المحلية مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك مجموعة من العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية, التي شكلت بمجملها البيئة التي تفاعلت في ظلها الأحزاب مع بعضها البعض سواء أكان ذلك في السلطة أو في المعارضة سلبا أو إيجابا, ومن خلال هذا التفاعل تم وضع المعالم الرئيسية الحاكمة للعملية السياسية, والتي يبرز منها علي المستوي الداخلي السمات الآتية:
- معاناة معظم الأحزاب السياسية من أزمات داخلية مستفحلة, كانت سببا وراء الانقسامات المتكررة.
- استمرار هيمنة السلطة التنفيذية علي بقية السلطات, وتنامي قوة وفعالية القيود والضوابط الدستورية والقانونية المحددة لمبدأ تداول السلطة, وكذا لقدرة هذه الأحزاب علي ممارسة وظائفها وأدوارها المنوطة بها, وتغلغلها الجماهيري, وهو ما أفضي- في المحصلة النهائية- إلي إفراغها من مضمونها الحقيقي, وتماثل برامجها وضيق مساحة تحركها, وبالتالي بقاءها أسيرة للأزمات.
- تحول الساحة السياسية إلي ميدان للمنافسة بين الأحزاب السياسية الثلاثة الفاعلة, مستفيدة من ذلك مما تستحوذ عليه من إمكانات, وحضور فاعل في الحياة السياسية اليمنية(14).
- ومن واقع ما أحرزته تجربة الانتخابات النيابية الثلاثة في الأعوام 1993, و1997 و2003, والمحلية عام2001, من نتائج ودلالات, مع الأخذ بنظر الاعتبار مجمل الظروف المحيطة بكل دورة انتخابية علي حدة, يتضح لنا ما يأتي:
1- إن مدخلات ومخرجات عملية الانتخابية النيابية الأولي لعام 1993, قد مثلت المحطة الرئيسية, التي رسمت المعالم الرئيسية للواقع السياسي اليمني, وحددت مساره طوال الـ13 سنة من حيث:
أ- لم يتعد عدد الأحزاب التي تقدمت ببرامج انتخابية ومرشحين الـ14 حزبا, بالإضافة إلى 7 أحزاب أخري تقدمت بمرشحين دون برامج من إجمالي عدد الأحزاب التي حظيت بتزكية قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية الصادر عام1991 طوال الـ 13 سنة, وفي حين بلغ عدد المرشحين في الإجمالي نحو الـ(4781) مرشحا, إلا أن الأحزاب لم تحظ منها, إلا بأقل من الثلث. أما باقي الأحزاب الـ25, فقد بقيت خارج العملية الانتخابية وعلي هامش الحياة السياسية.
ب- إن مخرجات هذه العملية قد أعادت رسم الخارطة السياسية لـ21 حزبا, وتصنيفها عموديا إلي أحزاب مركزية فاعلية حصلت علي أعلي عدد من المقاعد (مؤتمر, اشتراكي, إصلاح) وأحزاب فاعلية نسبيا يأتي في مقدمتها- حزب البعث العربي الاشتراكي القومي التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري, وأخري هامشية غير فاعلة التي لم تحظ بأية مقاعد.
جـ- إن بروز ظاهرة المستقلين وارتفاع نسبة مرشحيهم إلي أكثر من72% من إجمالي عدد المرشحين, فضلا عن حصولهم علي الترتيب الرابع تحت قبة البرلمان, قد ألقي بظلاله علي مدي جدية العملية السياسية والقائمين عليها في آن واحد.
أما مدخلات ومخرجات العملية الانتخابية النيابية للأعوام1997 و2003, فعلي الرغم من أنها مثلت تتويجا فعليا لمخاض عسير من علاقات التجاذب والتناحر بين الأحزاب, إلا أنها بحد ذاتها مثلث حدا فاصلا بين مرحلتين, حسمتا لصالح تفرد حزب المؤتمر الشعبي العام, بحصوله علي الأغلبية المريحة بدون منافس وقطعتا الطريق- نهائيا- أمام أية آمال تنشدها أحزاب المعارضة للوصول إلي سدة السلطة, أو المشاركة فيها مرة أخري, وبصورة انتقلت معها مجمل اهتمامات هذه الأحزاب إلي الاكتفاء بالمشاركة في إنضاج العملية السياسية بعيدا عن موضوع التداول السلمي للسلطة في ظل الاختلال الحاد في التوازن السياسي القائم,ومن هنا يمكننا أن نسجل بعض المؤشرات التي لها دلالاتها في هذا الشأن:
- بلغ عدد الأحزاب المشاركة في انتخابات 1997 حوالي12 حزبا فقط بسبب مقاطعة بقية الأحزاب لها وعلي رأسها الحزب الاشتراكي اليمني, شارك فيها قرابة الـ 2125 مرشحا, حظي المستقلون علي نسبة مرتفعة فيها, وجاءوا في المرتبة الثانية تحت قبة البرلمان, في حين تراجع التجمع اليمني للإصلاح إلي الترتيب الثالث.
- وبمشاركة الـ 21 حزبا المتواجدة في الساحة السياسية في انتخابات عام 2003 إلى جانب المستقلين, فإن عدد المرشحين لم يتعد الـ 1396 مرشحا. وفي هذه الانتخابات استعاد التجمع اليمني للإصلاح موقعه بعد المؤتمر الشعبي العام تحت مظلة البرلمان, فقد تراجع المستقلون والحزب الاشتراكي إلي المرتبة الثالثة والرابعة علي التوالي.
وفي حين جاءت نتائج عملية الانتخابات المحلية المنعقدة عام2001 لتمثل العامل المؤثر والحاسم وإن لم نقل الأكثر أهمية في الكشف عن واقع الحضور السياسي لهذه الأحزاب- بعد مرور عشرة أعوام- إذا من بين الـ(401) و(6213) مقعدا هي مقاعد المجالس المحلية في المحافظات والمديريات علي التوالي. لم تحظ أحزاب المعارضة, مجتمعة منها إلا علي الثلث فقط ومن بين ثلث هذه المقاعد, حاز التجمع اليمني للإصلاح والمستقلون علي أكثر من90% منها, وهو ما أعطي مؤشرا أكثر دقة عن مدي فعالية وحجم الأحزاب والتنظيمات العاملة في الساحة السياسية. أما مقاعد المجالس المحلية فقد انحصرت في المحافظات بين ثلاثة أحزاب متنافسة فقط فضلا عن المستقلين, أما في المديريات فقد أنحصرت المجالس المحلية بين(9) أحزاب متنافسة والمستقلين, وقد تراوح حجم الفجوة بين الفوز بـ 3771 مقعدا للمؤتمر الشعبي العام وبين الفوز بـ 1:7 مقاعد لأحزاب المعارضة.
وبنظرة عامة متفحصة في مجمل هذه النتائج نستطيع الخروج ببعض المؤشرات الدالة في هذا الشأن- كما يأتي:
1- إن هذه النتائج قد جاءت في ضوء التغير الجوهري الحاصل في قواعد اللعبة السياسية القائمة يبن أحزاب السلطة والمعارضة, لعل أبرز مؤشراته ما يأتي:
أ- تغير صيغة المعادلة السياسية الحاكمة للتنافس الحزبي- وفق ما يلي:
- مؤتمر- اشتراكي1990- 1993.
- مؤتمر- إصلاح- اشتراكي1993- 1994.
- مؤتمر- إصلاح 1994- 1997.
- مؤتمر1997- 2003 وحتى الآن.
ب- بروز أشكال مختلفة من الصيغ التفاعلية بين أحزاب المعارضة تبعا للمعادلة أعلاه وكما يلي(15):
- اتفاق تنسيق بين إصلاح. بعث, ثم بين إصلاح- بعث- ناصري1991-1993.
- التكتل الوطني للمعارضة عام1994 القريب من الحزب الاشتراكي اليمني- ضم في عضويته كلا من( التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري, التجمع اليمني الوحدوي, رابطة أبناء اليمن( رأي), حزب الحق, اتحاد القوي الشعبية), وفيما بعد برز تحت مسميات أخري مثل: مجلس التنسيق الأعلي لأحزاب المعارضة عام1995, ضم في عضويته 8 أحزاب هي (الحزب الاشتراكي, حزب البعث العربي الاشتراكي القومي, التنظيم الوحدوي الناصري, حزب الحق, التجمع اليمني الوحدوي, اتحاد القوي الشعبية, اتحاد القوي الوطنية, حزب الأحرار الدستوري), إلا أنه نتاجا لازدياد حدة الخلافات في المواقف, جمد بعض أعضائه أنفسهم إلى ما بعد الانتخابات النيابية لعام 1997, بعدها عادت بعض الأحزاب للعمل من خلاله, وعددها 5 أحزاب هي( الحزب الاشتراكي, التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري, حزب البعث العربي الاشتراكي القومي, حزب الحق, اتحاد القوي الشعبية).
- صيغة اللقاء المشترك عام 1996, ضم في عضويته (مجلس التنسيق الأعلي لأحزاب المعارضة+ الإصلاح).
- الائتلاف الديمقراطي للمعارضة عام 1994 ضم في عضويته عددا من الأحزاب المتعاطفة مع المؤتمر الشعبي العام, الذي أعيد تشكيله تحت اسم المجلس الوطني للمعارضة عام 1995, وضم في عضويته كلا من(الحزب الديمقراطي الناصري, التصحيح الشعبي الناصري, الجبهة الوطنية الديمقراطية, حزب جبهة التحرير, الحزب القومي الاجتماعي, حزب الرابطة اليمنية, حزب البعث العربي الاشتراكي( الذي جمد عضويته فيما بعد).
2- أما بالنسبة لمؤشر بروز تكتل المستقلين, فإن خط سير العملية الانتخابية برمتها, قد أكد حجم حضورهم السياسي الذي لا يمكن تجاهله بالرغم من التراجع النسبي والحاد سواء في عدد مرشحيهم للانتخابات من حيازته على ما يقارب من ثلثي إجمالي عدد المرشحين في انتخابات 1993, إلى النصف في انتخابات 2003, أو في نسبة عدد المقاعد التي فازوا بها من 15% إلى 4.7% في انتخابات1993 و2003 على التوالي.
3- إضافة إلي ما توحي به بعض المؤشرات من دلالات إيجابية وسلبية لعل أبرزها:
- تراجع عدد المرشحين(الحزبيين/ غير الحزبين) في انتخابات 1993 و2003 من 4781 مرشحا إلى 1307 مرشح.
- عودة الأحزاب السياسية الـ 21 للعمل ضمن الأطر الرسمية بعد فترة انقطاع لـ 9 أحزاب.
- انعدام القدرة التنافسية لأحزاب المعارضة مع بعضها البعض من جهة وفيما بينها وبين الحزب الحاكم من جهة أخري طوال الدورة الحالية.
ثانيا: القبيلة ودورها في الحياة السياسية اليمنية
لعبت القبيلة في اليمن منذ بداية وجودها, وعبر تاريخها الطويل, الممتد في عمق التاريخ اليمني, دورا فاعلا ومؤثرا في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية اليمنية, وتتميز التكوينات القبلية في المجتمع اليمني, بطبيعتها المنفرة كجماعات مرتبطة بالأرض, حيث يعيش معظم رجال القبائل في مناطق ريفية أو شبه ريفية, ويعمل معظمهم بالزراعة, وقد أدت سياسة الإغراق وعدم الانفتاح علي العالم التي فرضت علي المجتمع اليمني, إلي عرقلة تطوره ونموه الثقافي والسياسي(16).
وتستند القبيلة اليمنية في وجودها علي عدد من العوامل التي أسهمت في بقائها من أبرزها قوة الاعتقاد بصلة الدم والنسب المشترك, والارتباط الدائم والإقامة في رقعة جغرافية تسمي باسم القبيلة, والمشاركة في البحث عن مصادر اقتصادية مشتركة, وفرض وجودها بقوة علي خريطة التوازنات السياسية في الساحة اليمنية(17).
مما جعل الظاهرة القبلية في المجتمع اليمني, تتميز بخاصيتين أساسيتين هما: حضور سياسي داخل بناء القوة الرسمي. والاحتفاظ ببناء قوي قادرة علي مواصلة النمو الذاتي(18).
(أ) القبلية والمشاركة السياسية:
وفقا لمعيار طبيعة الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية المحيطة بالتفاعلات السياسية في الساحة اليمنية بأبعادها الداخلية والخارجية, فإنه سوف يتم النظر إليها من خلال بعدين:
أولا: القبيلة اليمنية والمشاركة السياسية قبل الوحدة: لم يعرف المجتمع المدني في اليمن أثناء فترة التشطير أي نوع من الممارسة الديمقراطية في الحرية والمشاركة السياسية, حيث أن الأنظمة التي تولت الحكم في أي من الشطرين كانت مختزلة في شخصية القائد, أو من خلال أحد الأشكال السياسية الأحادية الرأي(19).
وقد كانت الحزبية مجرمة في الشطر الشمالي من اليمن( سابقا) لدرجة أن الأنظمة السياسية المتوالية والمستمدة ثقافتها السياسية من ثقافة المجتمع التقليدي القبلي, كانت ترفع شعار أن الحزبية تبدأ بالعمالة وتنتهي بالخيانة(20).
إلا أن ذلك لا ينفي قيام عدد من الأحزاب في إطار العمل السري, بتجنيد عدد من مشايخ القبائل والقيادات العسكرية في صفوفها, ثم التأثير من خلالهم في خارطة التفاعلات السياسية التي شهدتها الساحة اليمنية, ويأتي في مقدمة تلك الأحزاب (حزب البعث), وفي نفس الاتجاه مثل الدعم السعودي للعديد من المشايخ المؤثرين, عامل تأثير علي التوجهات السياسية للأنظمة الحاكمة المتعاقبة في شطر اليمن' الشمالي', وفي المقابل فقد فشلت الأحزاب ذات التوجه الماركسي, من الاستقرار في المناطق الشمالية, بسبب تهمة الإلحاد التي وصفت بها, وكذا شحة الإمكانيات التي كانت تبذلها للمشائخ(21).
أما في الشطر الجنوبي من اليمن (سابقا) فقد أخذ تأسيس الدولة الجديدة بعد الاستقلال في30 نوفمبر1967, بعدا أيديولوجيا ثوريا, واحتل الطابع الأيديولوجي مكانا بارزا علي الصعيد الداخلي, تجسد بالصراع بين قوي اليمين واليسار حول تحديد هوية النظام الجديد, والذي انتهي بتغلب الجناح اليساري في الجبهة القومية, بعد حركة 22 يونيو1969(22). وإذا كان قد تم إدماج الأحزاب والتيارات السياسية في إطار الحزب الاشتراكي اليمني, والذي نشأ متجاوزا الواقع التقليدي للمجتمع اليمني, فقد انتهي إلي قبائل ممزقة بين عدة ولاءات شخصية ومناطقية(23) وصراعات داخل أجنحته المختلفة ذات الميول المناطقي والقبلي, وصولا إلي حدوث مجازر دموية عبرت عنها أحداث 13 يناير1916(25).
ثانيا: القبيلة ودورها في المشاركة السياسية بعد قيام الوحدة: لم يأخذ التحول الديمقراطي الذي تنبأ به' صامويل هانتنجتون من خلال ما كتبه عن الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين(24). طريقه إلي التطبيق العملي لدي الكثير من بلدان العالم الثالث ومنها اليمن, إلا في أعقاب تغيير التوازن الدولي لصالح المعسكر الغربي بعد انهيار الاتحاد السوفيتي, واتجاه الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة نحو نشر المفاهيم الغربية عن الديمقراطية وحقوق الإنسان, وهي القضايا التي لم تكن واردة بشكل كبير في مفردات السياسة الخارجية للولايات المتحدة خلال مرحلة الحرب الباردة, ولم تكن القيادة اليمنية بعيدة عن إدراك أهمية الأخذ بالمبادئ الديمقراطية في مساعيها نحو إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وذلك لتحقيق هدفين أساسيين: الأول: إيجاد صيغة مناسبة للعمل السياسي المشترك في ظل دولة الوحدة, يضمن لكلا النظامين في الشطرين قبل الوحدة حرية مواصلة توجهاتهما السياسية المختلفة. الثاني: مواكبة الموجة الديمقراطية التي أفرزتها المتغيرات الدولية.
مما يعطي انطباعا بأن ارتباط الوحدة اليمنية عضويا بالتعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة, والممارسة الديمقراطية, لم يكن في الأساس قرارا مفروضا من الخارج, وإنما كان يعكس المخاوف التي ارتبطت بتوقيع اتفاقية الوحدة, واعتبرت بمثابة صمام أمان وحماية للنظامين الشطرين السابقين, وهو ما يجعلنا نرجح أن الأخذ بالقيم الديمقراطية واحترام التعددية الحزبية, إنما جاءت مواكبة لميلاد دولة الوحدة, ولم تكن لتعبر عن نتاج تراكم طبيعي في البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في كلا الشطرين قبل ذلك الوحدة (26).
وقد عكس هذا الواقع نفسه علي الخارطة الحزبية في الفترة الأولى لقيام الوحدة بإعلان أكثر من 46 حزبا وتنظيما سياسيا عن نفسها, كما اندفع كثير من المواطنين لتأسيس العديد من منظمات المجتمع المدني الطوعية والتي وصلت عام 2000 إلى 2786 منظمة وجمعية ونقابة في مقابل 286 فقط عام 1990(27).
وقد شكل التحول الديمقراطي والأجواء المفعمة بالتعددية السياسية, عامل دفع لمشايخ ورموز القبائل في الانضمام للموكب الديمقراطي واحتوائه من خلال المشاركة بالإعلان عن ميلاد وقيادة عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية, كما شاركوا في إنشاء بعض منظمات المجتمع المدني, وبالنظر لطبيعة مشاركة رموز القبيلة في التعددية السياسية, فقد ترأس الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر تكوين أكبر حزب يمني معارض هو حزب التجمع اليمني للإصلاح, والذي يضم شريحة واسعة من مشايخ القبائل ورموز تيار الإسلام السياسي في اليمن, كما انضم الشيخ مجاهد أبو شوارب في بداية مرحلة التعددية إلي حزب البعث, و توزع عدد من المشايخ علي الأحزاب السياسية الأخري(28). والتي يأتي على رأسها المؤتمر الشعبي العام.
فالقبيلة مازالت هي العنصر الأقوي في التركيبة الاجتماعية في اليمن, وإذ كانت الأحزاب قد سعت لاستخدام القبائل لمآربها السياسية, فإن القبائل قد سعت هي الأخري للاستفادة من الأحزاب في مراكز السلطة, لتحقيق مشاريعها ومتطلباتها, إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة أن الغلبة ما زالت للقبيلية(29). مما دفع بالكثيرين للاتجاه نحو محاولة التخفيف من حدة الهيمنة القبلية علي الأحزاب والتنظيمات السياسية وقيادتها لها, بالرغم من الشوط الذي قطعته الأحزاب اليمنية في خلق أطر وطنية, بدأت تتجاوز المناطق والتجمعات التقليدية والعشائرية(30).
(ب) القبلية اليمنية والتفاعلات السياسية:
تمثل تجربة المشاركة السياسية أحد أضلاع المثلث الديمقراطي, من خلال التصويت والفاعلية في الدورات الانتخابية التي بدأت مع مسيرة الوحدة, وفي إطار المشاركة السياسية من خلال الانتخابات فإن وجود القبائل ونسبتهم في أي حزب, هو مصدر نجاحه الانتخابي, وتبلغ نسبة القبائل في اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام (43%) وكانت نسبتهم في انتخابات 1993(69%) من إجمالي مرشحي المؤتمر الشعبي العام, أما حزب البعث فقد شكل المشايخ المكون الأساسي له وكان من بين أهم رموزه الشيخ مجاهد أبو شوارب, وبفضل ذلك استطاع الحزب أن يحصل على(7) مقاعد في انتخابات1993, أما حزب الإصلاح فقد اختار أحد الزعامات القبلية رئيسا له وهو الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر, وبلغت نسبة التمثيل القبلي في الهيئة العليا المنبثقة عن المؤتمر العام الثاني للإصلاح (25%)(31).
أما عن حجم التأثير الذي تمارسه القبيلة من خلال مشاركتها في العملية السياسية, فإن ذلك يظهر في عدد أعضاء مشايخ القبائل الذين احتلوا مقاعد مجلس النواب, حيث تمكن عدد كبير من شيوخ القبائل من الوصول إلي مجلس النواب بنصيب تجاوز نصف قوام المجلس البالغ (301) عضوا, أما إذا ما تم الانتقال إلي انتخابات المجالس المحلية والتي أجريت في شهر فبراير2001, فإنه بالرغم من ضعف المشاركة السياسية لدي المواطنين بصفة عامة, فإن هذه الانتخابات قد أسفرت عن ميلاد قطاع عريض من المشايخ وأبنائهم المبتدئين في مسيرة العمل السياسي(32).
قائمة الهوامش والمراجع:
1- للمزيد ينظر في ذلك: د. بلقيس أحمد الصايدي, حركة المعارضة اليمنية, (بيروت: دار الأداء,1983). وعبد الله الذيفاني, الاتجاه القومي في حركة الأحرار اليمينيين1918-1948, (صنعاء: مركز الدراسات والبحوث اليمني, 1986). وأحمد عطية المصري, النجم الأحمر فوق اليمن,(بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية,1988).
2- وهو ما اتضح أكثر في نصوص ومضمون اتفاقية القاهرة عام1972, التي تضمنت مشروعا بذلك- تقدم به الطرفان- مع بقاء مفهوم التعددية الحزبية غير واضح, ثم اتفاقهما علي إنشاء لجنة التنظيم السياسي الموحد عام1981, تنفيذا لما جاء في بيان طرابلس في نفس العام ينظر في ذلك: أحمد جمال شمسان وآخرون, التعدية الحزبية والتحول الديمقراطي في اليمن1993-2003, بحث(غ.م) مقدم إلى قسم العلوم السياسية- جامعة القاهرة, 2005, ص6.
3- عبد الكريم الحطاب, ظاهرة الاستقرار السياسي في الجمهورية العربية اليمنية, رسالة دكتوراه(غ.م), (جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 1986), ص243.
4- أحمد جمال شمسان وآخرون, مرجع سابق, ص9.
5- التقرير الاستراتيجي اليمني لعام 1997,( صنعاء: المركز اليمني للدراسات الإستراتيجية, 1997), ص55.
6- د. بلقيس محمد جمال, حركة القوميين العرب, (دمشق: المركز العربي للدراسات الإستراتيجية, 1997), ص366 ينظر كذلك: محمد العزي عبد الحق الحميري,' تأثير المتغيرات الدولية علي العلاقات اليمنية- الأمريكية'، رسالة ماجستير غير منشورة (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية, قسم العلوم السياسية,2003)، ص ص110-111.
7- أحمد جمال شمسان وآخرون, مرجع سابق ص9.
8- المرجع نفسه, ص6.
9- أحمد محمد الهياجم, التشكيلات الوزارية في الجمهورية اليمنية1990-2005, رسالة ماجستير(غ.م), (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية قسم العلوم السياسية, 2006), ص18. وتشير بعض المصادر الرسمية إلى أن عددها قد وصل الـ 46 حزبا وتنظيما سياسيا, قبل صدور قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية عام 1991, الذي عمل علي ترشيدها من خلال القوانين أو الممارسة إلي قرابة 21 حزبا. ينظر في ذلك: المرجع نفسه, ص ص15-16.
10- أحمد الهياجم, مرجع سابق, ص25.
11- ينظر في ذلك: المرجع نفسه, ص25 وص ص38-30. وأحمد أحمد الشرعبي وآخرون, الدورة الانتخابية الكاملة, سلسلة كتب(4), ( صنعاء: المركز العام للدراسات والبحوث والإصدار,( ب.ت), ص15 وص43.
12- بالإضافة إلي أحزاب أخري مثل حزب الشوري, حزب المنبر اليمني الحر, حركة النهضة, حزب الله, الرابطة الشرعية, الحزب الإسلامي الديموقراطي, حركة التوحيد والعمل الإسلامي, جمعية الحكمة, التنظيم السروري, جماعة مقبل الوادعي.. ينظر في ذلك: د. فارس السقاف, الحركات الإسلامية والعنف في اليمن, في: اليمن والعالم, (صنعاء: مركز دراسات المستقبل,2002), ص ص404-421.
13- تشير التقارير الرسمية في هذا الشأن إلي هذه الأحزاب والتنظيمات السياسية (التنظيم الناصري الحر, تنظيم التصحيح الشعبي الناصري, التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري, تنظيم الطلائع الوحدوية الناصرية, الحزب الناصري الديمقراطي, منظمة الصقور الناصرية, الطلائع الوحدوية الناصرية, منظمة المرابطين الناصريين, الحركة الشعبية الناصرية, جبهة التصحيح الديمقراطية الوحدوية) ينظر في ذلك حزام عبد الله الديب, الحرية السياسية في اليمن, (صنعاء: مكتبة خالد بن الوليد, 2003), ص ص141-142. والتقرير الاستراتيجي اليمني لعام 1997, (صنعاء: المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية, 1998), ص63.
14- للمزيد من التفاصيل ينظر في ذلك التقرير الاستراتيجي اليمني لعام 2002, (صنعاء: المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية, 2003), ص ص54-56.
15- المرجع نفسه, ص ص71-73.
16- سمير العبدلي,'الثقافة السياسية الديمقراطية للقبائل اليمنية', رسالة دكتوراه غير منشورة, (القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية, قسم العلوم السياسية, 2003)، ص ص53-55.
17- المصدر السابق, ص ص57-58.
18- عبد الملك المقرمي,' بناء القوة في المدينة اليمنية'، رسالة دكتوراه غير منشورة, ( القاهرة: جامعة القاهرة, كلية الآداب, 1986), ص ص167-168.
19- محمد الصبري وآخرون,' ندوة الديمقراطية والأحزاب في اليمن.. الواقع.. الأفاق المستقبلية' (صنعاء: مركز دراسات المستقبل, 1998), ص148.
20- محمد محسن الظاهري, الدور السياسي للقبلية في الجمهورية العربية اليمنية1962-1990'، رسالة ماجستير غير منشورة, (القاهرة: جامعة القاهرة, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, 1995), ص178.
21- إلهام محمد مانع,' الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن1948-1993' مجلة الثوابت (صنعاء: الأفاق للطباعة والنشر,1994), ص23.
22- محمد العزي عبد الحق الحميري, مرجع سابق, ص111.
23- رياض الريس, رياح الجنوب: اليمن ودوره في الجزيرة العربية1990-1997, ( بيروت: رياض الريس للكتب والنشر, سبتمبر1998), ص314.
24- محمد العزي عبد الحق الحميري, مصدر سابق, ص122.
25- صامويل هانتجتون, الموجة الثالثة التحول الديمقراطي في أواخر القرن العشرين, ترجمة: عبد الوهاب علوب (الكويت: دار سعاد الصباح, 1993), ص9.
26- محمد العزي عبد الحق الحميري, مصدر سابق, ص ص160-161.
27- تقرير التنمية البشرية2000-2001, (صنعاء: وزارة التخطيط والتنمية, 2001), ص26.
28- سمير العبدلي، مصدر سابق, ص99-100.
29- رياض الريس, مصدر سابق, ص ص296-297.
30- سمير العبدلي، مصدر سابق, ص100.
31- بلقيس أبو اصبع, الأحزاب السياسية والتحول الديمقراطي في اليمن (القاهرة: مكتبة مدبولي,2004), ص ص271-272.
32- سمير العبدلي, مصدر سابق, ص ص103-104.
|
